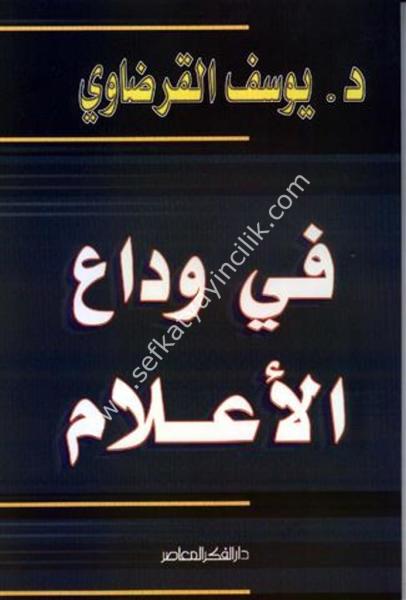مقدمة
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله وأنبيائه محمد، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن أكرم الناس منزلة، وأرفعهم مقاماً عند الله، وأكثرهم نفعاً لخلقه، هم أنبياء الله تعالى ورسله، الذين جعلهم الله سفراء بين السماء والأرض، ورسل الخالق لإصلاح الخلق، وإخراجِهم من الظلمات إلى النور، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهم الذين اصطفاهم الله، وكلفهم أن يدعوا الناس لعبادته، ويعيدوهم لشريعته، ويحثوهم على ابتغاء مرضاته، وأن يجتنبوا الطاغوت أيّاً كان اسمه ورسمه، {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصامَ لَها} [البقرة: 2/256].
ولكن جرت سنة الله في الخلق أن كل حي يموت، وأن لا أحد من الناس جعل الله له الخلد، كما قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} [الزمر: 39/30]، {وَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ} [الأنبياء: 21/34].
فإذا مات الأنبياء لم تمت رسالتهم، ولم تنته مهمتهم، بل يقوم بها من بعدهم خلفاؤهم وورثتهم، الذين يحملون مشاعل النور، ومصابيح الهداية للناس، حتى لا تندرس معالم النبوة الهادية، وحتى تظل حجة الله قائمة على الناس،{قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ} [الأنعام: 6/149].
ومن هنا قال رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام: ((العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظٍّ وافر)) قال الإمام الغزالي: ومعلوم أنه لا رتبة فوق رتبة النبوة، ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة.
وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ((إن الله وملائكته، وأهل السماوات والأرض، وحتى النملة في جحرها، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير)) .
لاسيما (العلماء الربانيين) وهم الذين يتجسد علمهم خلقاً وسلوكاً يوجه حياتهم، ويصبغ علاقتهم بالله، وعلاقتهم بالناس، ثم هم يقتدون بالرسل في تعليم الناس ما علمهم الله، ودعوتِهم إلى طريق الله، وصبرِهم على ما أصابهم في سبيل الله. فالرباني الحق هو الذي يعْلم ويعمل ويعلّم، كما أشار إلى ذلك القرآن بقوله: {وَلَكِنْ كُونُوا رَبّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ} [آل عمران: 3/79].
أجل، هم العلماء الربانيون الذين يعلمون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيصدقون، ويصدقون فيثبتون. على الصدق يحيون، وعلى الصدق يموتون.
ولا ريب أن وجود هؤلاء العلماء العاملين المعلمين الدعاة في أمة من الأمم: إنما هو رحمة من الله بها، ونعمة من الله عليها. فهم الذين يبينون الحقائق، ويردون على الأباطيل، ويدحضون الشبهات، ويصححون المفاهيم، ويأخذون بأيدي الناس إلى ساحة الله. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويقولون الحق ولو كان مراً، ويصدعون بأمر الله، لا يخافون لومة لائم، ولا نقمة ظالم، ولا سطوة حاكم، فهم من، {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاّ اللَّهَ} [الأحزاب: 33/39].
وهم الذين روي في مثلهم الحديث القائل: ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله: ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين)) .
فلولا هؤلاء الهداة، لطغى الجهل على العلم، وغلب الضلال على الهدى، وغطت ظلمات الباطل على نور الحق، وانهزم جند الخير أمام جحافل الشر.
وإذا كان وجود هؤلاء العلماء رحمة وبركة ونعمة على الأمة، فإن موتهم ولا شك مصيبة، وفقدهم رزية، وغيابهم عن الساحة كارثة، لاسيما إذا لم يوجد من يسد مسدهم، ويحرس تركتهم، ويحيي تراثهم.
ولهذا قال بعض السلف: ((ذهاب قبيلة أيسر من ذهاب عالم)).
وقال علي رضي الله عنه: ((إذا مات العالم ثلمت في الإسلام ثلمة، لا يسدها إلا خلف منه)).
وإن المصيبة تكبر وتتعاظم إذا تتابع موت العلماء الأفذاذ في وقت يسير، كما رأينا في المدة الأخيرة، حتى مات في سنة واحدة عدد من الأعلام المرموقين، كأنما هم حبات عقد انفرط مرة واحدة.
وإن أخطر شيء على حياة الأمة المعنوية: أن يذهب العلماء، ويبقى الجهال، الذين يلبسون لبوس العلماء، ويحملون ألقاب العلماء، وهم لا يستندون إلى علم ولا هدىً ولا كتاب منير. فهم إذا أفتوا لا يفتون بعلم، وإذا قضوا لا يقضون بحق، وإذا دعوا لا يدعون على بصيرة، وهو الذي حذر منه الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن عمرو ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبق عالماً، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا)) [متفق عليه].
ولعل هذا الشعور هو الذي دفعني في السنوات الأخيرة أن أمسك بالقلم لأودع العلماء الكبار بكلمات رثاء، أبين فيها فضلهم، وأنوّه بمكانتهم، والفجيعة فيهم، حتى يترحم الناس عليهم، ويدعوا لهم، ويجتهدوا أن يهيئوا من الأجيال الصاعدة من يملأ فراغهم، وإلا كانت الكارثة.
إن مما يؤسف له حقاً أن يموت العالم الفقيه، أو العالم الداعية، أو العالم المفكر، فلا يكاد يشعر بموته أحد، على حين تهتز أجهزة الإعلام، وتمتلئ أنهار الصحف، وتهتم الإذاعات والتلفازات بموت ممثل أو ممثلة، أو مطرب أو مطربة أو لاعب كرة أو غير هؤلاء، ممن أمسوا (نجوم المجتمع)،.
وأسف آخر أن العلمانيين والماركسيين وأشباههم إذا فقد واحد منهم، أثاروا ضجة بموته، وصنعوا له هالات مزورة، وتفننوا في الحديث عنه، واختراع الأمجاد له، وهكذا نراهم يزين بعضهم بعضاً، ويضخم بعضهم شأن بعض. على حين لا نرى الإسلاميين يفعلون ذلك مع أحيائهم ولا أمواتهم، وهذا ما شكا منه الأدباء والشعراء الأصلاء من قديم، حتى قال قائلهم:
المنكرون لكل أمر منكر
|
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم
|
بعضاً، ليدفع مُعْور عن مُعور،
|
وبقيت في خلْف يزيّن بعضهم
|
لهذا كان لزاماً علينا أن نعرف بعلمائنا وأعلامنا ومفكرينا ودعاتنا، فهذا حقهم علينا، وحق الأجيال أيضاً: أن نعرفهم بهم، ونصلهم بتراثهم.
وأود أن أنبه هنا على أمر، وهو أني كتبت عن الشخصيات التي أعرفها، وكانت لي بها صلة متينة، بحيث أعرف من معالم سيرتها ومسيرتها وعطائها ما يمكنني من الكتابة عنها، وإعطائها حقها.
وأما من لم تكن لي به مثل هذه الصلة، فلم أكتب عنه، ولعله يستحق الكتابة مثل الآخرين.
كما أن الشخصية قد تستحق الكتابة، ولي بها من الصلة ما يوجب ذلك، ولكن لم تساعدني الأقدار على ذلك لمرض أو سفر أو نحو ذلك، ولهذا لم أكتب عن عدد من الشخصيات التي رحلت عن دنيانا، وكنت أود أن أسهم بالكتابة عنها، مثل شيخنا الشيخ محمد متولي الشعراوي، والشيخ عبد الحميد كشك، والشيخ خالد محمد خالد، والشيخ عبد الفتاح أبو غدة، والشيخ مناع القطان، والشيخ ناصر الدين الألباني، والشيخ صلاح أبو إسماعيل، بيد أن الظروف لم تواتني.
وقد حاولت استدراك ذلك بالحديث عنهم في خطبة الجمعة، التي تذاع في فضائية قطر، أو في حلقة برنامج (الشريعة والحياة) من قناة (الجزيرة) في قطر، أو برنامج (المنبر) من قناة (أبو ظبي) الفضائية.
على أني قد استدركت الحديث عن معظم الشخصيات التي حالت ظروفي دون الكتابة عنهم عند وفاتهم، وذلك في (مذكراتي) التي تناولت مسيرة حياتي، فقد تناولت عدداً من هذه الشخصيات وغيرها، متحدثاً عنها حسب سياق الأحداث، وبما عاصرته من مواقف، أستطيع بها الحكم والحديث عن الشخصية المتحدث عنها، فقد تناولت الحديث عن الشيخ الشعراوي والشيخ مناع القطان والشيخ خالد محمد خالد والدكتور سعيد رمضان والدكتور عبد العزيز كامل، وغيرهم من الدعاة الكثيرين، مما لا مجال لحصره هنا، محاولة لأداء بعض ما لهم من حقوق أخوة العلم والإسلام، والعلم رحم بين أهله.
أنا أعرف أن من الباحثين المعاصرين من لا يعول إلا على الجماهير، ولا يعول على النخب المثقفة والقيادات الفكرية والدينية والسياسية، ويشكك في الحكمة المأثورة ((صنفان من الأمة إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس: العلماء والأمراء)).
ولا ريب أن الاهتمام بالجماهير، والتركيز عليها أمر واجب، وقد جاء في الحديث ((عليكم بالسواد الأعظم))، ((عليكم بالجماعة والعامة))، بل جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام ((إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم)).
فأشار إلى أهمية الفئات الضعيفة في المجتمع، مثل العمال والفلاحين والحرفيين، فهم عدة الإنتاج في السلم، وعدة النصر في الحرب، وهو معنى ((ترزقون وتنصرون)).
ولكن من المؤكد أن الشعوب والجماهير كثيراً ما يشغلها هم لقمة الخبز، وستر العورة، وضروريات العيش، عن التفكير في قضايا الإصلاح وقضايا المصير، حتى عن قضاياهم ومطالبهم الخاصة.
لهذا كانوا في حاجة إلى من يوقظهم من رقود، ويبعثهم من همود، ويحركهم من جمود، وينور عقولهم بالمعرفة، ويحرك عزائمهم بالإيمان، ويدفعهم إلى العمل والتكاليف من أجل حياة طيبة، يرضون فيها ربهم، ويسعدون فيها أنفسهم، ويخدمون فيها وطنهم وأمتهم.
وهذا هو دور العلماء والدعاة والمفكرين، وحملة الأقلام، الذين يقودون أوطانهم وشعوبهم في معارك التحرير والاستقلال، ومعارك النهوض والبناء، ولاتزال الأمة بخير ما كان لأهل العلم والفكر كلمة مسموعة في توجيه مسيرتها، وترشيد حركتها، وتسديد خطاها على الطريق القويم.
ويا ويل أمة يقودها الجهال والضالون، الذين لا يؤدون أمانتها، ولا يرعون رسالتها، ولا يحترمون خصوصيتها، فهم كما قال الشاعر:
|
فإنك قد أسندتها شر مسند!
|
إذا أنت حملت الخؤون أمانة
|
وفي صحيح البخاري: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ((إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة)) قال: وكيف إضاعتها؟ قال: ((إذا وسُد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)).
ولكل أمة ساعة تذهب فيها عزتها، وتضيع سيادتها، ويسيرها غيرها، وذلك إذا كان زمامها في غير أولي الأيدي والأبصار.
وإنا لندعو بما كان يدعو به أسلافنا الصالحون: اللهم ولّ أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ونعوذ بك من زمن يسود فيه الرؤوس الجهال.
الأستاذ أنور الجندي
راهب الثقافة والفكر
علمت بالأمس أن الكاتب الإسلامي المرموق الأستاذ أنور الجندي قد وافاه الأجل المحتوم، وانتقل إلى جوار ربه، منذ الإثنين الماضي 28/1/2002م، بلغني ذلك أحد إخواني، فقلت: يا سبحان الله، يموت مثل هذا الكاتب الكبير، المعروف بغزارة الإنتاج، وبالتفرغ الكامل للكتابة والعلم، والذي سخر قلمه لخدمة الإسلام وثقافته وحضارته، ودعوته وأمته أكثر من نصف قرن، ولا يعرف موته إلا بعد عدة أيام، لا تكتب عنه صحيفة، ولا تتحدث عنه إذاعة، ولا يعرِّف به تلفاز، كأن الرجل لم يخلف وراءه ثروة طائلة من الكتب والموسوعات، في مختلف آفاق الثقافة العربية والإسلامية، وقد كان عضواً عاملاً بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، ومن أوائل الأعضاء في نقابة الصحفيين، وقد حصل على جائزة الدولة التقديرية سنة 1960م.
لو كان أنور الجندي مطرباً أو ممثلاً لامتلأت أنهار الصحف بالحديث عنه، والتنويه بشأنه، والثناء على منجزاته الفنية.
ولو كان لاعب كرة، لتحدثت عنه الأوساط الرياضية وغير الرياضية، وكيف خسرت الرياضة بموته فارساً من فرسانها، بل كيف خسرت الأمة بموته كله نجماً من نجومها، ذلك أن أمتنا تؤمن بعبقرية (القدم) ولا تؤمن بعبقرية (القلم).
مسكين أنور الجندي، لقد ظلمته أمته ميتاً، كما ظلمته حياً، فلم يكن الرجل ممن يسعون للظهور وتسليط الأضواء عليه، كما يفعل الكثيرون من عشاق الأضواء الباهرة، بل عاش الرجل عمره راهباً في صومعة العلم والثقافة، يقرأ ويكتب ولا يبتغي من أحد جزاء، ولا شكوراً، كأنما يقول ما قال رسل الله الكرام: {وَما أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاّ عَلَى رَبِّ الْعالَمِينَ} [الشعراء: 26/109] .
منذ كنت طالباً في القسم الثانوي بالأزهر، وأنا أقرأ لأنور الجندي في القضايا الإسلامية المختلفة، ومن أوائل ما قرأت له كتاب بعنوان (كفاح الذبيحين فلسطين والمغرب)، وكتاب عن (قائد الدعوة) يعني: حسن البنا الذي طوره فيما بعد وأمسى كتاباً كبيراً في حوالي ست مئة صفحة، سماه (حسن البنا الداعية المجدد والإمام الشهيد)، وقد طبعته دار القلم بدمشق عدة طبعات، في سلسلتها (أعلام المسلمين) وافتتحت به سلسلتها. وكان حسن البنا هو الذي دفعه إلى الكتابة، فقد كان في رحلة حج معه، وطلب منه أن يكتب خاطرة، فقرأها، فأعجبته، فشجعه وأثنى على قلمه، وحرضه على الاستمرار في الكتابة.
وكان من كتبه الأولى (اخرجوا من بلادنا) يخاطب الإنكليز المحتلين، وقد علمت أن الكتاب كان سبباً في سجنه واعتقاله عدة أيام في عهد الملك فاروق، ثم أفرج عنه.
وللأستاذ أنور الجندي كتب كثيرة تقارب المئة كتاب، بعضها موسوعات، مثل كتابه: (مقدمات المناهج والعلوم)، الذي نشرته دار الأنصار بالقاهرة بلغت مجلداته عشرة من القطع الكبير. وموسوعته (في دائرة الضوء) قالوا: إنها من خمسين جزءاً. ومن أهم كتبه: (أسلمة المعرفة)، (نقد مناهج الغرب)، (أخطاء المنهج الغربي الوافد)، (الضربات التي وجهت للأمة الإسلامية)، (اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار)، (تاريخ الصحافة الإسلامية).
وكان آخر ما نشره: كتاب (نجم الإسلام لا يزال يصعد).
كان الأستاذ أنور الجندي يميل في كتاباته إلى التسهيل والتبسيط، وتقريب الثقافة العامة لجمهور المتعلمين، دون تقعر أو تفيهق أو جنوح إلى الإغراب والتعقيد، فكان أسلوبه سهلاً واضحاً مشرقاً، وكان الأستاذ الجندي لا يميل إلى التحقيق والتوثيق العلمي، فلم تكن هذه مهمته، ولم يكن هذا شأنه، ولذلك لا ينبغي أن يؤخذ عليه أنه لا يذكر مراجع ما ينقله من معلومات، ولا يوثقها أدنى توثيق، فإنه لم يلتزم بذلك ولم يدّعه، وكل إنسان يحاسب على المنهج الذي ارتضاه لنفسه، هل وفى به وأعطاه حقه أو لا؟
أما لماذا لم يأخذ بالمنهج العلمي؟ ألعجز منه أو لكسل، أو لرؤية خاصة تبناها وسار على نهجها؟
يبدو أن هذا الاحتمال الأخير هو الأقرب، وذلك أنه لم يكن يكتب للعلماء والمتخصصين، بل كان أكثر ما يكتبه للشباب، حتى إنه حين كتب موسوعته الإسلامية التي سماها (معلمة الإسلام) وجمع فيها 99 مصطلحاً في مختلف أبواب الثقافة والحضارة، والعلوم والفنون، والآداب والشرائع، جعل عنوان مقدمة هذه المعلمة: (إلى شباب الإسلام) وقال في بدايتها: ((الحديث في هذه المعلمة موجه إلى شباب الإسلام والعرب، فهم عدة الوطن الكبير، وجيل الغد الحافل بمسؤولياته وتبعاته، وهم الذين سوف يحملون أمانة الدفاع عن هذه العقيدة في مواجهة الأخطار التي تحيط بها من كل جانب، فمن حقهم على جيلنا أن يقدم لهم خلاصة ما وصل إليه من فكر وتجربة.. وأن نعيد لهم الطريق إلى الغاية المرتجاة.. هذه مسؤوليتنا إزاءهم، فإذا لم نقم بها كنا آثمين، وكان علينا تبعة التقصير)).
وأعتقد أن كتبه قد آتت أكلها في تثقيف الشباب المسلم، وتحصينهم من الهجمات الثقافية الغربية المادية والعلمانية، التي لا ترضى إلا بأن تقتلعهم من جذورهم وأصالتهم.
كان الأستاذ الجندي زاهداً في الدنيا وزخرفها، قانعاً بالقليل من الرزق، راضياً بما قسم الله له، لا يطمع أن يكون له قصر ولا سيارة، حسبه أن يعيش مكتفياً مستوراً، وكان بهذا من أغنى الناس، كان كما قال علي كرم الله وجهه:
ويغنى غني المال وهو ذليل
|
يعز غني النفس إن قل ماله
|
وكما قال أبو فراس:
ولو أنه عاري المناكب حافِ
|
إن الغني هو الغني بنفسه
|
وإذا قنعت فبعضُ شيء كافِ
|
ماكل ما فوق البسيطة كافياً
|
وكان أربه من الدنيا محدوداً، فليس له من الأولاد إلا ابنة واحدة، تعلمت في الأزهر، وحصلت على إجازة (ليسانس) في الدراسات الإسلامية من جامعة الأزهر، وكانت رغباته تنحصر في أن يقرأ ويكتب وينشر ما يكتب، كما سئل أحد علماء السلف: فيم سعادتك؟ قال: في حُجَّة تتبختر اتضاحاً، وشبهة تتضاءل افتضاحاً.
حكى الأخ الأديب الداعية الشيخ عبد السلام البسيوني أنه ذهب إلى القاهرة مع فريق من تلفزيون قطر ليجري حواراً مع عدد من العلماء والدعاة، كان الأستاذ أنور منهم أو في طليعتهم. ولم يجد في منزله الذي يسكنه مكاناً يصلح للتصوير فيه، فقد كان في حي شعبي مليء بالضجيج، وكان المنزل ضيقاً مشغولاً بالكتب في كل مكان، فاقترح عليه أن يجري الحوار معه في الفندق، وبعد أن انتهى الحوار، تقدم مدير الإنتاج بمبلغ من المال يقول له: نرجو يا أستاذ أن تقبل هذا المبلغ الرمزي مكافأة منا، وإن كان دون ما تستحق. فإذا بالرجل يرفض رفضاً حاسماً، ويقول: أنا قابلتكم وليس في نيتي أن آخذ مكافأة، ولست مستعداً أن أغير نيتي، ولم أقدم شيئاً يستحق المكافأة.
قالوا له: هذا ليس من جيوبنا، إنه من الدولة.. وأصر الرجل على موقفه، وأبى أن يأخذ فلساً،
وكان الأستاذ الجندي يكتب مقالات في مجلة (منار الإسلام) في أبو ظبي، وفوجئ القراء يوماً بإعلان في المجلة يناشد الأستاذ أنور الجندي أن يبعث إلى إدارة المجلة بعنوانه، لترسل إليه مستحقات له تأخرت لديها، ومعنى هذا أنه لا يطلب ما يستحق، ناهيك أن يلح في الطلب كالآخرين.
كان رجلاً ربانياً، ومن دلائل ربانيته ما ذكرته ابنته عنه أنه كان يحب أن يكون متوضئاً دائماً، فيأكل وهو متوضئ، ويكتب وهو متوضئ، وكان ينام بعد العشاء ثم يستيقظ قبل الفجر ليصلي التهجد، ويصلي الفجر، ثم ينام ساعتين بعد الفجر، ويقوم ليقضي بعض حاجات البيت بنفسه.
وكان يخدم الجيران، ويملأ لهم (جرادل) الماء إذا انقطع الماء، ويضعها أمام شققهم.
كان للأستاذ أنور الجندي من اسمه نصيب أي نصيب، فكانت حياته وعطاؤه وإنتاجه تدور حول محورين: النور - أو التنوير، والجندية.
فقد ظل منذ أمسك بالقلم يحمل مشعل (النور) أو (التنوير) للأمة، وأنا أقصد هنا: التنوير الحقيقي، لا (التزوير) الذي يسمونه (التنوير).
فالتنوير الحقيقي هو الذي يرد الأمة إلى النور الحق الذي هو أصل كل نور، وهو نور الله تعالى ممد الكون كله بالنور، وممد قلوب المؤمنين بالنور: نور الفطرة والعقل، ونور الإيمان والوحي: {نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ} [النور: 24/35].
وكان أهم معالم هذا التنوير مقاومة التغريب والغزو الفكري، الذي يسلخ الأمة من جلدها ويحاول تغيير وجهتها، وتبديل هويتها، وإلغاء صبغتها الربانية: {صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً} [البقرة: 2/138]، وكان واقفاً بالمرصاد لكل دعاة التغريب، يكشف زيفهم، ويهتك سترهم، وإن بلغوا من المكانة ما بلغوا، حتى رد على طه حسين وغيره من أصحاب السلطان الأدبي والسياسي.
وقال الجندي يوماً عن نفسه:
أنا محام في قضية الحكم بكتاب الله، مازلت موكلاً فيها منذ بضع وأربعين سنة، حيث أعدُّ لها الدفوع، وأقدم المذكرات، بتكليف بعقد وبيعة إلى الحق تبارك وتعالى، وعهد على بيع النفس لله، والجنة - سلعة الله الغالية - هي الثمن لهذا التكليف {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} [التوبة: 9/111].
كان النور والتنوير غايته ورسالته، وكانت الجندية وظيفته ووسيلته، لقد عاش في هذه الحياة (جندياً) لفكرته ورسالته، فلم يكن جندي منفعة وغنيمة، بل كان جندي عقيدة وفكرة. لم يجر خلف بريق الشهرة، ولم يسع لكسب المال والثروة أو الجاه والمنزلة، وإنما كان أكبر همه أن يعمل في هدوء، وأن ينتج في صمت، وألا يبحث عن الضجيج والفرقعات، تاركاً هذه لمن يريدونها ويلهثون وراءها.
كان الأستاذ أنور الجندي يحرص على أن يكون جندياً يعمل في الصفوف الخلفية، لا يسعى لأن يكون قائداً يشار إليه بالبنان، وكان همه أن يكون (جندياً مجهولاً) يعمل حيث لا يراه الناس، بل حيث يراه الله، فهو وليه ونصيره، وكفى بالله ولياً، وكفى بالله نصيراً.
كان الأستاذ الجندي من الإخوان المسلمين من قديم، وممن رافق الإمام البنا مبكراً، وممن كتبوا في مجلات الإخوان في الأربعينيات من القرن العشرين، ولكن الله تبارك وتعالى نجاه من كروب المحن التي حاقت بالإخوان قبل ثورة تموز (يوليو) وما بعدها، فلم يدخل معتقل الطور أيام النقراشي وعبد الهادي، ولم يدخل السجن الحربي أيام عبد الناصر، بل حصل على جائزة الدولة التقديرية في عهده، على حين لم ينلها أحد ممن كانت له صلة بالإخوان.
وربما كانت طبيعته الهادئة، وعمله الصامت، وأدبه الجم، وتواضعه العجيب، وبعده عن النشاط العلني في تنظيم الإخوان: سبباً في نجاته من هذه المعتقلات، خصوصاً في عهد الثورة.
كتب الأستاذ أنور الجندي في فترة المحنة في عهد عبد الناصر في بعض المجلات غير الإسلامية تراجم لقادة التحرر والثورة من ذوي التوجه الديني، أمثال عمر المختار في ليبيا وعبد الكريم الخطابي في المغرب، وذلك في مجلة (المجتمع العربي) المصرية، في فترة الخمسينيات والستينيات. ويقول عن هذه الفترة: ((لقد كان إيماني أن يكون هناك صوت متصل - وإن لم يكن مرتفعاً بالقدر الكافي - ليقول كلمة الإسلام ولو تحت أي اسم آخر، ولم يكن مطلوباً من أصحاب الدعوات أن يصمتوا جميعاً وراء الأسوار)).
في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، سعدت بلقاء الأستاذ الجندي في الجزائر العاصمة، في أحد ملتقيات الفكر الإسلامي، وهي أول مرة ألقاه وجهاً لوجه - بعد أن كنت رأيته مرة بالمركز العام للإخوان مع الأستاذ البنا، سنة 1947م على ما أذكر - فوجدته رجلاً مخلصاً متواضعاً، خافض الجناح، ظاهر الصلاح، نير الإصباح، وقد أرسلنا منظمو الملتقى إلى أحد المساجد في ضواحي العاصمة هو وأنا، وأردت أن أقدمه ليتحدث أولاً، فأبى بشدة، وألقيت كلمتي، ثم قدمته للناس بما يليق به، فسر بذلك سروراً بالغاً.
وبعد حديثه في هذه الضاحية تحدثت معه: لماذا لا يظهر للناس ويتحدث إليهم بما أفاء الله عليه من علم وثقافة؟ فقال: أنا رجل صنعتي القلم، ولا أحسن الخطابة والحديث إلى الناس، فأنا لم أتعود مواجهة الجمهور، وإنما عشت أواجه الكتب والمكتبة، وليس كل الناس مثلك ومثل الشيخ الغزالي ممن آتاهم الله موهبة الكتابة، وموهبة الخطابة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
فقلت له: ولكن من حق جمهور المسلمين أن ينتفعوا بثمرات قلمك، وقراءاتك المتنوعة، فتضيف إليهم جديداً، وتعطيهم مزيداً.
فقال: ((كلٌّ ميسرٌ لما خلق له)).
وفي السنوات الأخيرة حين وهن العظم منه، وتراكمت عليه متاعب السنين، وزاد من متاعبه وآلامه في شيخوخته ما رآه من صدود ونسيان من المجتمع من حوله، كأنما لم يقض حياته في خدمته أمته، ولم يذب شموع عمره في إحيائها، وتجديد شبابها، وكأنما لم يجعل من نفسه حارساً لهويتها وثقافتها، مدافعاً عن أصالتها أمام هجمات القوى المعادية غربيّة وشرقية، ليبرالية وماركسية.
عاش الأستاذ الجندي سنواته الأخيرة حلس بيته، وطريح فراشه، يشكو بثه وحزنه إلى الله، كما شكا يعقوب عليه السلام، يشكو من سقم جسمه، ويشكو أكثر من صنيع قومه معه، الذين كثيراً ما قدموا النكرات، ومنحوا العطايا للإمعات، كما يشكو من إعراض إخوانه، الذين نسوه في ساعة العسرة، وأيام الأزمة والشدة، والذين حرم ودهم وبرهم أحوج ما كان إليه، مردداً قول الإمام علي رضي الله عنه فيما نسب إليه من شعر:
|
إذا الريح مالت مال حيث تميل |
ولا خير في ود امرئ متلون |
|
وعند زوال المال عنك بخيل |
جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله |
|
ولكنهم في النائبات قليل |
فما أكثر الإخوان حين تعدهم |
ومنذ أشهر قلائل اتصلت بي ابنته الوحيدة من القاهرة، وأبلغتني تحيات والدها الذي أقعده المرض عن الحركة، وهو يعيش وحيداً لا يكاد يراه أحد، أو يسأل عنه أحد، بالرغم من عطائه الموصول طول عمره لدينه ووطنه وأمته العربية والإسلامية، وكانت كلماتها كأنها سهام حادة اخترقت صدري، وأصابت صميم قلبي، وطلبت منها أن تبلغه أعطر تحياتي، وأبلغ تمنياتي، وأخلص دعواتي له بالصحة والعافية، وسأعمل على زيارته في أول فرصة أنزل فيها إلى مصر بإذن الله.
وقد بعثت إليه في أول فرصة سكرتيري الخاص الأخ عصام تليمة يحمل إليه رسالة مني، أحييه، وأواسيه، وأشد من أزره في محنته التي يعانيها وحده.
وقد اتصلت بي ابنته بعدها هاتفياً من القاهرة، وقالت لي: إن والدي يشكرك كل الشكر على هذه الرسالة الأخوية الرقيقة، وإننا قرأناها، وأعيننا تفيض من الدمع، تأثراً بما جاء فيها ومعها. وقلت لها: إني لم أفعل شيئاً سوى بعض الواجب علي وعلى غيري نحو الأستاذ، وحقه على الأمة أكبر.. وعسى أن تتاح لي الفرصة لأعوده في مرضه، وأزوره في بيته، وشاء الله جلت حكمته، أن يتوفاه إليه قبل أن تتحقق هذه الزيارة، وأن يلقى ربه - إن شاء الله - راضياً مرضياً.
{يا أَيَّتُها النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً ، فَادْخُلِي فِي عِبادِي ، وَادْخُلِي جَنَّتِي} [الفجر: 89/27-30].
رحم الله أنور الجندي، وغفر له، وتقبله في الصالحين، وجزاه عن دينه وأمته خير ما يجزي به العلماء والدعاة الصادقين، الذين أخلصهم الله لدينه، وأخلصوا دينهم لله.
* * *